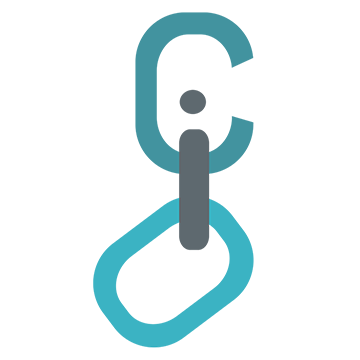“حال الحقوقيين اليوم”
إيمان عبدالله حُميد – رئيسة مركز إنصاف
طل علينا اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والإنسان في اليمن يعيش أكثر
أيامه ظلامية وانتزاعا لحقوقه، إذ تضيق مساحة الحريات والتسامح وتنبت مكانها
العصبية والظلم والقهر ومصادرة الحق في التعبير والحق في الاعتقاد والحق في الحركة
والحق في التفكير.
يأتي هذا اليوم وعلى الرغم من زيادة المعرفة بين البشر وزيادة
الاهتمام بالإنسان وحقوقه فإن اليمن تتحول من يوم إلى آخر إلى مواطن للتعصب وإلغاء
الآخر. وإلى جانب مصادرة حق الآخرين فإن الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان
يواجهون مصاعب مضاعفة لاسيما حين تكون هذه الناشطة أنثى، إذ يصبح الوضع أكثر
تعقيدا وأشد خطرا.
تتمثل أول خطورة أمام المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في طبيعة
الحملات الممنهجة الموجهة ضدهم بانهم مأجورين وممولين من الخارج وهو ما يجعلهم
بمثابة العملاء والجواسيس، وهذا الزعم يضاعف عليهم الخطر من جهة ويجعل الناس
أنفسهم يتنازلون عن حقوقهم ويخشون من الحديث عن حقهم مع هؤلاء الناشطين والناشطات
لانهم في نظرهم غير مأمونين على الدفاع عن حقوق الناس وهم العملاء للخارج.
ثاني خطر هو أن تكون هذه الناشطة أنثى وهي المهضومة حقوقها في مجتمع
ذكوري لا يرى في الأنثى إلا مصدرا للشبهة والشهوة فكيف يمكن أن يقبل منها إسهامها
في التوعية بحقوق الإنسان، وقد تم تصنيف النسوية حديثا في مجتمعنا بأنها تعادل
التطرف والإرهاب وهكذا يصبح الخطر مضاعفا.
الخطر الآخر والأكبر حين تكون هذه المدافعة أو المدافع متبنيا لحقوق
الأقليات لاسيما الدينية، وهذا ما حدث معنا بمركز إنصاف حيث يتم النظر الينا بريبة
حينا وباحتقار حينا آخر لأن المجتمع ينظر إلى هذا التصرف بأنه تحول في الدين إذ لا
يتم قبول أن تدافع عن حقوق طائفة أخرى أو أفراد ديانة أخرى، حيث ينعدم مفهوم
التسامح والدفاع عن حقوق الآخر.
والأمر كذلك بالنسبة للدفاع عن أقلية المهمشين، فأننا نواجه الكثير من
التحديات في ظل مجتمع ينظر الى الأقليات نظرة دونية وهنا يصبح التحدي كبيرا من أجل
مواجهة هذه التصرفات الغير سويه التي لا يقبلها المجتمع الا انه تأثر بها نتيجة
لعدم العمل بتشريعات الدستورية المقره والتي لم تتحول الى قوانيين تنفيذيه
بالتعامل معها الا اننا نراهن على قيم ووعي المجتمع من أجل التسامح والقبول بالآخر
والتكاتف والتعاون من أجل مصلحة الجميع.
إن الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام والأقليات بشكل خاص ينبغي أن
يتحول إلى نشاط عام لكل أفراد المجتمع، ذلك أن حق الأقليات هو حق الجميع وأن تبني
مفاهيم التسامح والقبول بالآخر هي أسس بناء مجتمع قوي متماسك ينهض بالفرد فيه من
أجل الجماعة.
___________________________________________

نساء المهمشين والتهميش المزدوج
شذى نبيل
تخرج سلمى 35 عاما كل صباح حاملة ابنتها الصغيرة معها، تلقي بنفسها في عربة نقل عمال النظافة المكشوفة لتنجز عملها المعتاد كل يوم حتى الظهر، ثم تتوجه إلى بيع المناديل في أحد شوارع مدينة المكلا، وقبل أن يكتمل النهار تقفل عائدة إلى بيتها حاملة بعض الغذاء وما يحتاجه كوخهم الصغير المصنوع من الصفيح المكون من غرفة واحدة والقابع على أطراف المدينة.
في رحلتها اليومية هذه لا تخلو من المتاعب والمضايقات ومحاولات السطو على حريتها أو حتى على كرامتها، فعلى الرغم من أنها تبذل أكثر من نصف يومها في الشمس والحر بحثا عن الرزق الحلال لا يزال البعض يرى فيها لقمة سائغة للافتراس فيحاولون التحرش بها ومضايقتها وفي أوقات كثيرة إهانتها لفظيا والتعدي على كرامتها بالشتائم والقذف.
عنف الشارع
يتميز مجتمع المهمشين نوعا ما بنوع من الحرية مع مختلف أبنائه، فنتيجة للوضع الاجتماعي الذي يضيق عليهم الخناق تعيش الأسر المهمشة في نوع من التكافل فيما بينها ولكن هذا لا يمنع أن تعاني المرأة أيضا داخل مجتمع المهمشين من تهميش مزدوج وعلى مناحي مختلفة. إن المرأة المهمشة تشارك في العمل أكثر من غيرها مقارنة بفئات المجتمع الأخرى، ولكن هذا الأمر يجعلها أكثر عرضة للتحرش، إذ تبين دراسة أُجريت على عينة من مئة امرأة ورجل في العاصمة صنعاء عن العنف المُمَارس ضد المرأة في الشارع، أثبتت أن المرأة تتعرض في الشارع اليمني لأشكال العنف النفسي (المعاكسة والتحرش) بصورة أكبر من أشكال العنف المادي[1]، ونحن نعلم أن أكثر النساء العاملات لاسيما في الشارع هن من نساء المهمشات وهو ما يجعل هذه النسبة ترتفع لتصل إلى أكثر من 90%.
تقول سلمى التي لا تجيد القراءة ولا الكتابة إن مرتبها في قطاع النظافة لا يكفي مصاريفهم هي وأبنائها، وهي تضطر لبيع المناديل كي تستكمل باقي النفقات، لقد عملت الحرب الأخيرة على مضاعفة الأسعار في ظل عدم وجود أي زيادة المرتبات وتقليص في مصادر الدخل، وهو الأمر الذي ضاعف من المشكلات على كاهلها وكاهل النساء من أمثالها تماما كما عملت الحرب على زيادة وتيرة الكثير من التحديات ضد هذه الفئة.
الحرب والعنف
لقد تحولت الحرب الأخيرة إلى جحيم على المرأة وعلى الأطفال وعلى بقية المجتمع، ولكن المشكلة تتضاعف على المرأة داخل مجتمع المهمشين إذ تدفع الكثير من ثمن هذه الحرب على أشكال مختلفة، إما بمضاعفة المعاناة الإنسانية والاجتماعية أو بزيادة حدة الانتهاكات التي تتعرض لها.
ونتيجة النزاع المسلح فقد ارتفع عدد المعيلات للأسر -من النساء بشكل عام- إلى ثلاثة أضعاف عما كان عليه قبل الحرب مما ضاعف من الأعباء على النساء مع شحة في الموارد وارتفاع في أسعار السلع الغذائية، وانخفاض حاد في الإنتاج الزراعي الذي تمثل النساء فيه حوالي 80% من الأيدي العاملة[2]، وتشارك المرأة من المهمشين في العمل بنسبة كبيرة إذ يمكن القول إن المرأة المهمشة هي أكثر مشاركة في العمل سواء من خلال العمل في مجل النظافة أو في المجالات الأخرى إذ ما أتيح لها ذلك، ولكن الحرب أثرت عليها بقوة فقد تقلص هذا الدور الذي كان متاحا أمامها، فانخفضت فرص العمل والعائدات من جهة وزادت الانتهاكات من جهة أخرى.
بحسب ما تنقله عائشة الوراق في بحث لها عن المهمشين، فقد واجهت النساء والفتيات من هذه الشريحة خطرا مستمرا من الاعتداءات على أساس النوع الاجتماعي أكثر من باقي النساء، حيث كانت نساء المهمشين أكثر تعرضاً للعنف الجنسي والتحرش من قبل المقاتلين[3]، وفي الحقيقة ليس من قبل المقاتلين فحسب ولكن من قبل بعض الأفراد الآخرين الذين استمرأوا الاعتداء على المهمشين وعلى النساء منهم تحديدا لأنهن الأكثر ضعفا وعدم قدرة على مواجهة الاعتداءات في ظل عدم وجود سلطات تحميهن أو تطالب بحقهن.
إن محنة سلمى وغيرها من نساء المهمشين أنها ليست من المهمشين فحسب ولكنها امرأة أيضا، وهو الأمر الذي يجعلها داخل سلسلة من التهميش المزدوج، مرة لأنها امرأة داخل مجتمع يهمش المرأة ولا يعطيها حقها المشروع لها قانونا، ومرة لأنها داخل مجتمع المهمشين المغيب والمعزول اجتماعيا.
استغلال
وفي ظاهرة أخرى لا تعكس الوضع البائس لمجتمع المهمشين فقط ولكنها بشكل ما توضح الشكل الذي تعيشه المرأة المهمشة، فهي إلى جانب حرمانها من التعليم والحق في الحياة الطبيعية، تنمو بعد ذلك الكثير من المشكلات الاجتماعية التي تعاني هي وحدها تبعاتها في ظل أمية متفشية وعدم وجود التكافل الاجتماعي الذي يمكن أن يحميها من كل هذه التبعات الخطيرة عليها أولا وعلى المجتمع ثانيا. إذ يصل الأمر إلى استغلال الفتيات الصغيرات من المهمشين إما بالتحرش أو بالمتاجرة بهن أو استغلالهن في التسول بصورة غير مشروعة، حيث لوحظ وجود بعض السماسرة ورجال عصابات، ممن لديهم مجموعات من أطفال الشوارع والفتيات الصغيرات، ومهمتهم جمع المال من الأماكن التي يختارونها لهم، كل يوم، ويقومون بتوزيعهم في سياراتهم ويعملون بالأجر اليومي[4] ومن ثم يذهب العائد بشكل غير مشروع لهؤلاء السماسرة الذي يتكسبون باستغلال الفتيات والأطفال، فلا وجود لمؤسسات ولا جمعيات تحميهن من هذه الانتهاكات المنظمة، ولا وجود لرادع اجتماعي لمثل هذه الممارسات المهينة واللاإنسانية.
والاستغلال لا يبقى عند هذا الحد فقط، إذ تفيد سعيدة 41 عاما بأن هناك بعض الناس من يستغلونها وأمثالها من نساء المهمشين للقيام بأعمال شاقة لا سيما في تنظيف الأماكن التي يرفض الآخرون القيام بها، وكل هذا بمقابل مادي لا يساوي شيئا، إذ غالبا ما يتم النظر لهن بأنهن خلقن فقط لخدمتهم وأنهن لسن كباقي البشر.
هل من أفق للحل؟
يحتوي دستور الجمهورية اليمنية على المادة 31 التي تنص على أن “النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون”[5]، ويبدو أن النص غير حاسم في النظر للمرأة وكيف معالجة مشاكلها ولا بما يتعلق بالمساواة إذ وضع الأمر في يد رجال الدين ليقرروا فيها وهو الأمر الذي لم ينتج قانونا واحدا يعزز دور المرأة في المجتمع. ولم يحو الدستور أي نص يتعلق بالمهمشين، لقد زادت -بعد العام 1990- بشكل متواتر حالة الانغلاق التي تعيشها المرأة والتقاليد الاجتماعية التي تقيد مشاركتها في الوقت الذي تضاعف فيه عدد السكان وصارت المرأة تشكل رقما كبيرا في المجتمع إلى جانب المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج الجميع، والأمر ينعكس بصورة أكثر مأساوية على المهمشين وعلى المرأة المهمشة.
بالمقابل يحتوي الدستور المقترح الذي كان نتيجة لمؤتمر الحوار في العام 2015 [6]مادتين عن المرأة: المادة 38 التي تنص على أن “تكفل الدولة تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في الاستثمار والتنمية الاقتصادية وتقديم الدعم والرعاية والتشجيع للمرأة الريفية في مختلف المجلات”، والمادة 57 التي تنص على أن “تلتزم الدولة بدعم ورعاية المرأة وسن القوانين التي تكفل حمايتها ورفع مكانتها في المجتمع والقضاء على الثقافة السلبية والعادات الاجتماعية التي تنتقص من كرامتها” كما يتضمن الدستور مادة أيضا عن المهمشين والتي تنص على أن “تلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية للنهوض بأوضاع الفئات الضعيفة والمهمشة، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعمل الدولة على إدماج المهمشين في المجتمع” وهذا يعكس أن من قاموا بكتابة هذه المسودة يدركون أن المرأة من الفئات الضعيفة وفي الوقت نفسه أن المرأة داخل مجتمع المهمشين ضعيفة مرتين.
إن الحل كما يبدو من النصوص أعلاه، هو بوجود تدابير تشريعية ولكن ينبغي أيضا تغيير النمط الثقافي السلبي والعادات التي تعادي جزءا مهما من منظومة الشعب، ومن ثم فإن الفائدة لن تكون للمرأة فحسب ولا لمجتمع المهمشين وحدهم ولكن للجميع فهم جزء أساسي من المجتمع اليمني ككل. إن محاولة البحث عن حل جذري لمشكلة المرأة في اليمن، ينبغي أن تبدأ من البحث عن مشكلة المرأة المهمشة فهي تعاني من تهميش على مستويات مختلفة بدءا من تهميش العرق وانتهاء بتهميش النوع الاجتماعي.
الهوامش:
[1] – نساء على أرصفة صنعاء عرضة للتحرش والابتزاز، محمد عبدالملك، العربي الجديد، 16 مارس، 2015.
[2] – أوضاع النساء في اليمن في ظل الصراع المسلح، التقرير السنوي الثاني عن أوضاع النساء في السياسة بالمنطقة العربية 2018، ملتقى النساء في السياسة بالمنطقة العربية.
[3] – التهميش التاريخي والممنهج لمجتمع المهمشين في اليمن، عائشة الوراق، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 31 ما يو 2019.
[4] – نساء على أرصفة صنعاء عرضة للتحرش والابتزاز، محمد عبدالملك.
[5] – دستور الجمهورية اليمنية، ص: 6.
[6] – ينظر المواد المشار إليها في مسودة دستور الجمهورية اليمنية التي كتبتها لجنة صياغة الدستور في العام 2015، وكان يفترض التصويت عليها ولكن جاءت الحرب الأخيرة وأنهت كل شيء، ص: 9، 11.
___________________________________________
أسوار تغلق الآفاق أمام المرأة في اليمن
شذى نبيل
في الوقت الذي تسعى فيه المملكة العربية السعودية باتجاه رسم سياسة اجتماعية وثقافية منفتحة، تشهد جارتها اليمن على العكس منها حالة من الانغلاق المتصاعد بفعل عدة عوامل منها داخلية ومنها خارجية. وحين يتعلق الحال بالمرأة ووضعها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي فإن هذا الأمر يأتي على رأس هذه المعوقات التي بدأت بالتعافي تدريجيا في المملكة، ولكنها على العكس من ذلك في اليمن.
كان اليمن يعيش قبل العام 1990 تقريبا، وقبل أن يشهد الوحدة اليمنية في ذلك الوقت كان يعيش حالة من الحرية النسبية لدى المرأة، ويعود ذلك إلى سببين، الأول هو النظام الاشتراكي الذي كان يحكم الجنوب وكان قائما على كثير من الأسس التي تقيم احتراما للمرأة ودورها في المجتمع، والسبب الثاني الثقافة الشعبية المحلية سواء في شمال اليمن أو في جنوبه والتي كانت تضع للمرأة مكانة مميزة تتسم بالاحترام والتقدير على نحو ما، لكنها لم تكن مثالية بالشكل المطلوب.
بعد هذا العام بدأ التحول التدريجي للمجتمع باتجاه الانغلاق، ساعد على ذلك عودة المجاهدين العرب من أفغانستان وبدء ظهور المعاهد والمراكز الدينية والتي بدأت تغذي التشدد وكانت المرأة هي المرتكز التي تشتغل عليها تلك الحلقات الدراسية في المساجد المنتشرة في عموم البلاد. بدأت تتحول ثقافة المرأة حتى في الثقافة الشعبية، وبدأ تصوير ذلك الاحترام للمرأة على أنه جاهلية وأن المجتمع يعيش حالة من “الجهل” وأن على المجتمع أن يصحو من هذه الغفلة، فاتجه المجتمع بشكل جماعي نحو تقييد حرية المرأة وتقييد مشاركتها في الجوانب السياسية والاجتماعية واقتصر عملها على المنزل والأسرة.
تترافق التطورات الأخيرة في المملكة العربية السعودية مع الاصلاحات الاقتصادية التي تعمل على نزوح مئات الآلاف من اليمنيين باتجاه بلادهم الأصل، هؤلاء النازحون هم من تربوا على تلك القيم التي يحاول المجتمع السعودي الآن التخلص منها وتحديثها، وهؤلاء النازحون سيضيفون عبئا جديدا للمجتمع اليمني على المستوى الاقتصادي المتدهور بفعل الحرب أصلا وعلى المستوى الاجتماعي لا سيما المرأة.
ففي الوقت الذي بدأت فيه المرأة السعودية بقيادة السيارات وتحقيق بعض المكتسبات السياسية والاقتصادية فإن هؤلاء العائدين يرون أنهم عائدون لحماية هذه القيم التي يشهدون نهايتها في المملكة ولن يكون معهم من مجال مفتوح لإبقاء معتقادتهم تلك إلا في المجتمع اليمني حيث ستعمل المرأة على دفع الثمن من مستقبلها.
كلما تحاول المرأة في اليمن أن تضع لنفسها خطوة في سبيل تحقيق ذاتها والإسهام بخدمة مجتمعها تجد مئات الأسوار تمتد أمام وجهها، بدءا من المؤسسات المحافظة وانتهاء بالمرأة نفسها التي لم تعد تقبل الخطاب الذي يركز على الحقوق وغالبا ما يتم الربط بين النشاط الحقوقي وبين العمالة والكفر والخيانة.